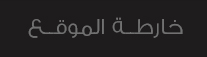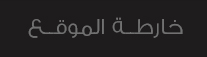|
توزّعت جوائز «مهرجان ڤينيسيا» على مستحقيها غالباً. هذا
الاستحقاق يشمل الفيلم الفائز بالجائزة الأولى (الأسد الذهبي)، والفيلم
الفائز بالجائزة الثانية (الأسد الفضي) الذي يُطلق عليه أيضاً اسم «جائزة
لجنة التحكيم الكبرى»، وجوائز أفضل تمثيل (نسائي ورجالي) وأفضل إخراج،
وأفضل سيناريو من بين جوائز أخرى.
في الواقع هناك مسابقتان رئيسيّتان، واحدة لأفلام المسابقة
الرئيسية، والأخرى لأفلام قسم «آفاق» والنتائج كانت عادلة وواقعية بالنسبة
للمسابقتين في حفل حاشد ختم به المهرجان دورته الثانية والثمانين.
دورة رائعة
ترددت الآراء ما بين أن دورة العام الحالي جاءت أفضل من
العام الماضي، وأن أفلام هذه الدورة كانت أفضل من أفلام دورة «مهرجان كان»
المنافس.
كلا الرأيين انتشر بين كثير من النقاد والصحافيين الذين
قصدوا المهرجانين الكبيرين. الجانب الذي يحتاج إلى جهد أفضل من قِبل
«ڤينيسيا» هو عملية توزيع الأفلام المشتركة (9 أقسام) على نحو يؤكد
أهميّتها أكثر من مجرد تركها لشأنها بعد برمجتها وتوزيعها على الصالات
الـ11 المخصصة للمهرجان والمتقاربة ضمن مساحة جغرافية واحدة.
الجوائز الممنوحة كانت من التنوّع بحيث لم يتم إغفال فيلم
أحدث ضجة بعد عرضه، خصوصاً فيلم كوثر بن هنية «صوت هند رجب» الذي تعامل مع
القصّة الحقيقية للفتاة ذات الـ12سنة التي وجدت نفسها بين جثث أقارب لها
بعدما استُهدفت السيارة التي كانت تقلهم.
لساعة ونصف الساعة، نسمع تضرعها عبر تسجيل صوتي فعلي لها
استُخدم جيّداً وبشكل مؤثر. لا مشاهد لهند رجب كون الأحداث الدرامية اختيرت
لها. وبمهارة أيضاً، تدور الأحداث في مكاتب «الهلال الأحمر الفلسطيني» في
رام الله.
تمتَّع الفيلم بأفضل استقبال تحقق لأي من أفلام المهرجان.
ليس لأن التصفيق الحاد الذي تبع عروضه امتد أكثر من 20 دقيقة فقط، بل
أساساً لأمانة وإخلاص عرضه لتلك المأساة التي انتهت باستشهاد الفتاة بعدما
طال انتظارها النجدة.
أحد الذين اقتربوا من الممثل معتز مليس، الذي لعب أحد
الدورين الرجاليين الرئيسيين (لجانب عامر حليحل)، كان الممثل الأميركي
خواكين فينكس، الذي طبع على خد معتز قبلة تجسد مشاعره.
كثير من الحضور مسح دموعه، والأكثر منهم من منحه إعجابه على
نحو أو آخر تجلى مع استقبال جيّد من قِبل نقاد عالميين كثر. كان واضحاً
كذلك أن الفيلم مرشح للفوز بإحدى الجائزتين الأولى أو الثانية، وهو مُنح
فعلاً الجائزة الفضية وسط تصفيق حار آخر.
إلى محافل أخرى
بالمناسبة، تردّد اسم فلسطين إيجاباً 4 مرّات خلال حفل
الاختتام. مرّة عندما وقفت المخرجة الهندية أنوبارنا روي التي تسلمت جائزة
أفضل مخرج عن فيلمها «أغاني الأشجار المنسية»
(Songs of the Forgotten Trees)،
ومرة ثانية عندما فاز المخرج المكسيكي ديڤيد بابلوس بجائزة أفضل فيلم في
مسابقة «آفاق» وعنوانه «على الطريق»
(En El Camino)،
ثم مرّة ثالثة على لسان الممثل الإيطالي توني سرڤيلو حين تسلم جائزة أفضل
تمثيل رجالي عن بطولته لفيلم «شكر»
(La Gracia).
المرّة الرابعة هي عندما وصل إعلان الجوائز إلى ذروته بتقديم الفيلم الفائز
بالذهبية وهو «أب أم أخت أخ» للأميركي جيم يارموش، الذي طالب باحترام كرامة
الفلسطينيين.
«أب
أم أخت أخ»، هو جديد المخرج المستقل جيم يارموش، والوصف «مستقل» ينطبق على
أعماله جيّداً، كما على أعمال رئيس لجنة التحكيم ألكسندر باين الذي صوّت،
مع أعضاء اللجنة، لفوز هذا الفيلم بالأسد الذهبي.
دراما تتخذ سبيلاً مختلفاً في عرضها للعلاقات العائلية بين
أفرادها الأربعة عن كل فيلم آخر سبق أن تعرّض للهامش العريض نفسه. منح
يارموش بطولة هذا الفيلم إلى مجموعة واثقة بالممثلين من بينهم أدام درايڤر
الذي سبق له أن ظهر في فيلمين سابقين ليارموش هما «باترسون»
(Paterson)،
و«الموتى لا يموتون» .(
في (2016 و2019 ،(The
Dead Don’t Die)
الجائزتان، الذهبية والفضية، تبدوان «كارت بلانش» لمزيد من
الجوائز في المحافل والمناسبات المقبلة.
بين الأفلام الفائزة بجوائز «ڤينيسيا» «تحت السحب»
(Below the Clouds)
لجيانفرانكو روزي: فيلم تسجيلي عن المصير الذي تتوقعه مدينة نابولي لنفسها
مع البركان الذي يطل عليها والهزات الأرضية التي تعيش فوقها. نال الفيلم
جائزة لجنة التحكيم الخاصّة (البرونزية حسب تواردها).
وإذ فاز توني سرڤيلو بجائزة أفضل ممثل كما ورد، تم منح
الممثلة جين شيلاي المقابل النسائي عن دورها في الفيلم الصيني «الشمس تشرق
علينا جميعاً»
(The Son Rises on Us All).
جائزة أفضل إخراج نالها الأميركي بني سافدي عن «الآلة
المحطِّمة»
(The Smashing Machine)
هذه هي الجائزة الوحيدة التي كانت هناك بدائل لها من بين الأفلام
المتسابقة. دراما رياضية من بطولة دواين جونسن وإميلي بلنت حول صعود وهبوط
المصارع الحر مارك كير. الفيلم جيد التنفيذ، لكن جودته لا تنطلي على اختيار
معالجة فنية ترتقي بحكايته.
ما ينتظره المتابعون بعد نهاية المهرجان الحافل هو توجه
الفيلمين الفائزين بالجائزتين الأولى والثانية («أب أم أخت أخ» و«صوت هند
رجب») إلى دخول عرين السباقات الأخرى في أوروبا (عبر جوائز بافتا وغيرها)
والولايات المتحدة (عبر الأوسكار). وبالنسبة لفيلم كوثر بن هنية، فهذه فرصة
سانحة لدفع الفيلم لمزيد من الجوائز وسط وعي إعلامي وجماهيري جديد وغير
مسبوق بما يقع في تلك الحرب غير العادلة. |